
ترميم الدولة أم تدميرها – نقاشات حول الحرب والسلام (2). عبدالله بشير
من خلال ما تتعرض له الدولة من تدمير في بنيتها التحتية والقيمية بسبب هذه الحرب، رأينا أنه من المناسب أن يقدم المرء رأيًا قويمًا فيما يراهُ صائبًا ومفيدًا؛ لأهمية وجود الدولة بمؤسساتها المختلفة بما فيها بالطبع، مؤسسة الجيش؛ جادلت في الجزء الأول من المقال؛ بأن الدولة لم تكن في يوم من الأيام جهة جغرافية أو فئة عرقية معينة؛ إنما في الأصل تقوم الدولة وتتمحور حول منظومة متكاملة، وعلى ذلك المنحى يتم البناء والتخطيط صعودًا علي السلم السياسي والاقتصادي والإجتماعي والامني، ونزولاً إلي كيفية إدارة حياتنا اليومية كأساس للبناء، ومن المناسب أكثر أن يكون هذا الرأي قد جاء كتعليل تطوري لأراء بذلناها كمؤسسة حزبية وأفراد، وقدمنا فيها إطارًا نضع من خلاله قضايا الأمن القومي، والترتيبات الأمنية؛ كترتيب لازم لإعادة ترميم الدولة. ونذهب في الجزء الثاني من المقال؛ للنقاش أكثر ليس فقط في أهمية وجود الدولة، من ناحية نظرية فقط، وإنما من ناحية وأقعية، مع ربط ذلك بالفاعلين السياسيين، من منظومات سياسية، ومنظمات مجتمع مدني، والتحالفات السياسية، وأهمية دورها كمؤسسات مكملة للدولة، وجدوى ما تقوم به في إصلاح الشأن العام.إستقرار الرأي لدى مجموعات ليست بالقليلة، على فهم قاصر فيما يتعلق بدور الدولة وأهميتها في تنظيم حياة الشعوب و المجتمعات، وظني أن ذلك يعود بسبب إختزال تلك الفئات والمجموعات، الدولة في النظام الحاكم، أو المؤسسة العسكرية فقط؛ ويأتي ذلك نسبة للدور الكبير الذي لعبته مؤسسة الجيش في الحياة السياسية السودانية عبر الانقلابات العسكرية، منذ الإستقلال؛ فنمت عندهم فكرة أن تحطيم تلك المؤسسة وتدميرها هو المدخل لبناء تلك الدولة التى فى مخيلتهم؛ لكن الواقع يقول ”أن الفكر الإنساني لم يجد بعد منظومة أفضل من الدولة لإدارة شؤون الشعوب والمجتمعات وتنظيمها أفضل من الدولة“.وفي هذا الصدد يجادل الأكاديمي المرموق الدكتور قصي همرور، مقدمًا مرافعة مهمة حول دور الدولة وأهميتها في تنظيم شؤون الشعوب، و يتسائل إن كان هنالك أيّ منظومة أو فكرة خلاف الدولة تستطيع توفير الإدارة والتنسيق الشامليين لنُظم الخدمة المدنية والخدمات العامة، والأشغال العامة مثّل تشغيل وصيانة خدمات المياه والكهرباء، والصرف الصحي، وإنشاء وصيانة الطرق والجسور والموانئ، والنظام الصحي، والنقل والمواصلات، وتنظيم متطلبات القطاع الصناعي والزراعي والتعديني، من بنية تحتية وشروط إدارية ومالية وفنية، وتنظيم قضايا العمل والتأهيل الفني والإداري لتسيير كل هذه النظم المتعلقة بحركة الناس والتكنولوجيا وطرائق العيش الجديدة في مجتماعات الحداثة، أو التخطيط المدني والريفي، أو الإحصاء والإرصاد ومراقبة جودة السلع، والتجارة الدولية، و العلاقات الدولية، تنسيق نظم الطيران المدني داخل وخارج النطاق الجغرافي للدولة، لسيادة المجتمع، أو ترتيب النظم العسكرية الحديثة، والتي بدونها لن تكون للدولة سلطة تنفيذية، أو فض النزاعات بين الجماعات المسلحة، أو إتفاقيات مشاركة موارد المياه، والأجواء والمعابر، وكذلك الإتفاقيات الإقليمية والدولية السياسية). هذا هو دور الدولة، أيّ دولة كانت في هذا الكوكب سواء كانت دولة 56 التي يريدون تحطيمها أو أيّ دولة أخرى، والمؤسسة العسكرية جزء من الدولة. المنطق السليم يقول إن أىّ قصور أو تدهور في هذه المؤسسات يتم إصلاحه وترميمه بخطط وبرامج وأضحة، وليس تدميره؛ فتحطيم جهاز الدولة وتدميره، لا يعني بأيّ حال من الأحوال تدمير الكيزان أو الفلول.لان السودان كدولة موجودة قبل الكيزان أو الفلول. عندما إندلعت شرارة هذه الحرب، حدث إختلاف كبير حول أهداف الحرب، ومن بدأها؛ بالرغم من أن هنالك شواهد يمكن الإستناد عليها لمن أراد معرفة ذلك، إبتدأ من أجواء التوتر التي كانت تسود البلاد، ثم حالة الإنقسام والتشظي الواضح بين المنظومات السياسية والعسكرية، والحشود العسكرية، والطموح السياسي الذي تنامى لهذه القوات، وغيرها من الشواهد، إلا أن هنالك رواية وأحدة وغير متماسكة، وكان هنالك إصرار شديد على انها هي الصحيحة. وهي التي تقول أن فلول النظام السابق هم من أشعل هذه الحرب للعودة إلى السلطة مرة أخرى، وقطع الطريق أمام الإتفاق الإطاري. تم تمرير هذه الرواية للإستفادة من المزاج الشعبي العام الرافض لعودة الكيزان للسطة مرة أخرى بعد الإطاحة بنظام حكمهم في العام 2019م. ربما إنخدع الكثيرين من دعاة التحول الديمقراطي والدولة المدنية بتلك الرواية، بسبب تسارع الأحداث، حيث كان من الصعب توصيف ما حدث بشكل دقيق، وتحديد كيف سارت الأمور بهذه السرعة، وإنتهت إلى إنفجار داوي للأوضاع بهذه الطريقة المأسوية؛ لكن مع مرور الوقت، بدأت الخيوط تتضح والحقيقة تظهر أكثر وضوحًا، وإن كان ثمة ” فلول” يجب إبعادهم من المشهد، بالطبع، يجب أن يشمل هذه القوات الموازية للمؤسسة العسكرية الرئيسية أيضًا، لأن وأحدة من تلك الحقائق المعلومة للجميع أن الإسلاميين عبر نظامهم السابق، وفي سبيل تمكين حكمهم، صنعوا هذه القوات الموازية داخل الدولة، ومكنوها و وفروا لها الغطاء السياسي، ودافعوا عنها؛ فقولها أنها تخوض هذه الحرب بغرض القضاء على الإسلاميين أو من أجل التحول الديمقراطي قوّل غير صحيح على الإطلاق، وإن كان الإسلاميين فلول فهذه القوات من أدوات الفلول، صنعت لتنفذ لهم اهدافهم؛ كأداء من أدوات حكمهم وبطشهم، والثورة قامت في الأساس ضد حكومة الإنقاذ، التي صنعت هذه القوات الموازية داخل الدولة؛ بالتالي ينطبق عليها ما ينطبق على النظام البائد. ثم القوّل أن هذه القوات كشفت أعيب الكيزان وتخلت عنهم وأمنت بالثورة والتغيير، ويبدو أن هنالك من أحسن الظن بذلك من خصوم الإسلاميين، وأعتقد أن تلك فرصة للتخلص من خصم عنيد وقوى بأدواته التي صنعها، لكن خاب ذلك الظن، لان الأمر في نهاية المطاف؛ كمن يضع يده مع الشيطان وينتظر دخول الجنة. بينما كانت تلك الحرب تشتد ضراوةً، وتستهدف السودانيين بشكل مباشر، معظم القوى السياسية الموقعة أو الداعمة للإتفاق الإطاري، تبنت الرواية التي تقول أن الفلول هم من أشعلوا الحرب لمنع إستكمال الإتفاق الإطاري الذي يُمهد لتكوين الحكومة المدنية، وبموجب ذلك وضعت نفسها في موضع “الحياد” أو قُل موقف الحياد؛ بقولها أن ذلك يمنع الإصطفاف خلف طرفي الصراع، ويحد من إحتمال إطالة الحرب وتمدد الصراع؛ وهو موقف ضبابي يخفي خلفه توجهات سياسية تحاول الإستفادة من الوضع؛ لتصفية خصوماتها السياسية. لأن المنظومات السياسية ذات المشاريع السياسية المستمدة من الواقع، لا يمكن أن تكون في “الحياد”، في مثّل هذه القضايا الكبيرة التي ثؤثر على مستقبل الشعوب، وقد كان ذلك الموقف بلا شك بمثابة السير نحو مصالح المليشيا بوضع هذا الغطاء السياسي، والذي يُعد الضوء الأخضر لشرعنة الحرب ضد الفلول وهزيمة الإخوان المسلمين، من ناحية، ومن ناحية أخرى، وجدتها فرصة أخرى لتأسيس وضعية جديدة داخل سلطة الدولة وشرعنة وجودها بشكل مستقل، وعرض سلاحها للشاري الجديد، وتكون بذلك مسحت تاريخها السابق مع الفلول، وغسلت ماضيها الدموي. ولم تكن وحدها من يحاول صنع تاريخ جديد يتجاوز ماضي مشاركة النظام البائد طوال عهده، هناك مجموعات سياسية وأشخاص يحاولون مسح ذلك الماضي بأدعاء ثورية مصطنعة، لكن فاتهم جميعا أن التاريخ هو التاريخ.ثم لاحقًا عندما إجتاحت المليشيات البلدات الآمنة وعاثت فيها فسادًا، وفشلت رواية الحرب ضد الفلول، وتحولت إلى حرب ضد المواطن، تم الترويج بأن موقف الحياد قائم على الوقوف مسافة وأحدة من طرفي الصراع حتى لا يؤدي الإصطفاف إلى إندلاع حرب أهلية، ولكن دون الإجابة على هذا السؤال المهم، من الذي يريد تحويل الحرب إلى حرب أهلية؟، الذي يجلس في بيته في بلدة نائية في الجزيرة أو سنار أو الجنينة، حيث لا يوجد في تلك البلدة مركز شرطة ناهيك عن قاعدة عسكرية، أم الذي يأتي من أقاصي البلاد ويعتدي على المواطن ويخرجه من منزله، ويهينه أمام أسرته، ويسطو على مدخراته التى هي شقاء عمره، في هذه الحالة لا أعتقد أن الحياد منطقيًا، لأن الواقع يقوّل إن المعتدي هو الذي يريد أن يحول الحرب إلى حرب أهلية، إلا أن محنة الناس هذه يتم إستخدامها للحصول على مكسب سياسي. بتنامى الغضب الشعبي تجاه المليشيا وإنتهاكاتها، وبدأت تتشكل كتائب المقاومة الشعبية، للدفاع عن الأنفس والأسر والممتلكات، ومع ظهور بوادر تبدل المشهد عكس ما تم الترويج له في بداية الحرب، شعر التحالف الذي يقف على “الحياد”؛ بأن واقعًا جديدًا سوف يتشكل بدونه، وبالتالي شرع في تكوين تحالف مدني جديد على أنقاض التحالف القديم الموقع على الإتفاق الإطاري، بأسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” من أجل إيقاف الحرب هذه المرة، وتأسيس سلطة مدنية، بتكوين أكبر قاعدة مدنية ضد الحرب، فقط هكذا! وضم أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات مهنية ومستقلين وشخصيات وطنية. بالطبع تعتبر التحالفات السياسية من أدوات العمل الحزبي، وسوف تظل موجودة ما وجد العمل السياسي، والتاريخ السوداني حافل بهذه التحالفات، معظمها نجح بالفعل في مهمته سيما في جانب إسقاط الأنظمة الدكتاتورية، ويمكن تسمية كل تلك التحالفات بتحالفات “إسقاط”، لكن بعد سقوط النظام تظهر الإختلافات، في نهاية المطاف تنهار التجربة، وحتى هذه اللحظة لا يوجد تحالفات متينة للبناء. لا أريد هنا أن أتنبأ بمستقبل تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية “تقدم” أو أيّ تحالف سياسي أخر قد ينشأ مستقبلاً، لكن الحقيقة أن “تقدم” لن تتجاوز المرحلة التي وصلت إليها سابقاتها، لأن فكرة أن يضم تحالف وأحد أحزاب من أقصى اليمين، تطالب بالدولة الدينية، مع أحزب من أقصى اليسار تطالب بالدولة العلمانية، مع احزاب إشتراكية وأخرى في الوسط، في تحالف وأحد. إختلاف كامل في المشاريع السياسية والفكرية لهذه الأحزاب؛ فأقصى ما يمكن أن تصل إليه هذه الأحزاب من إتفاق هو إسقاط النظام القائم، وقد حدث ذلك بالفعل عدة مرات في التاريخ السياسي السوداني؛ ثم بعد سقوط النظام، ولعدم توفر أدنى إتفاق بين المتحالفين حول مشروع للحكم والبناء الوطني، من جميع النواحي، عادة ما يتم الإتفاق في نهاية المطاف على أن تكون الحكومة التي تقود المرحلة الإنتقالية حكومة غير حزبية، وهي فكرة خاطئة تمامًا، وأثبتت فشلها أكثر من ثلاث مرات، لأن من الخطأ توكيل أمر إدارة دولة معقدة مثّل السودان لشخصيات غير سياسية، وتجريب فكرة فشلت من قبل وإنتظار نتيجة مختلفة لذات أسباب الفشل في المرات السابقات، أمر غير مفهوم البتة، وأرجو أن لا يفهم من حديثي أنني ضد التحالفات السياسية، بالطبع لا؛ لكن إذا كان لا بد منها؛ فيجب أن تقوم بين من لهم نفس الرؤية والأهداف والبرنامج والتوجه السياسي، ربما قد يساعد ذلك على إتفاقهم في شأن إدارة الدولة متى ما أصبحوا في السلطة.للتو إنتهت تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية “تقدم” من مؤتمرها التأسيسى، والأمر اللافت في هذا التحالف، هو علو كعب منظمات المجتمع المدني، وتراجع دور الأحزاب السياسية، وهو وضع مختل تمامًا، لصالح منظمات المجتمع المدني، مع أن جميع القضايا المطروحة هي قضايا سياسية، وتحتاج إلى حلول سياسية يتصدى لها قادة وطنيين، وليس منظمات مجتمع مدني، وفي ذلك إنتصار لأجندة المجتمع المدني على حساب الأجندة السياسية، وبينهما إختلاف كبير في الرؤى والبرامج و الاهداف، والوضع في السودان يحتاج إلى قادة سياسيين وطنيين يتحملون مسؤلياتهم تجاه الدولة والشعب، وليس موظفين أمضوا معظم حياتهم في المنظمات غير الحكومية، والأمر المثير للسخرية، أن “تقدم” التي تبنت رواية أن الفلول هم الذين بدؤوا الحرب، ضمت بداخلها الإخوان المسلمين المتمثل حزب المؤتمر الشعبي، مهندس إنقلاب الإنقاذ 1989م، الذي حكم السودان في عشرية الإنقاذ الأولى الأكثر دمويةً في تاريخ السودان السياسي؛ حيث كانت بيوت الأشباح والإغتيالات والإحالة للصالح العام، وتمكين كوادر الإخوان في الدولة؛ فإذا إستطاعت “تقدم” الجلوس مع الكيزان الحقيقيين، أصحاب فكرة الدولة الإسلامية، فمن باب أولي الجلوس مع الآخرين الأقل رادكالية. لا أحد يستطيع أن ينكر دور منظمات المجتمع المدني وتأثيرها في الحياة العامة، والخدمات الجليلة التي تقدمها في عدة مجالات؛ فهي تعمل وتتحرك في المساحات التي تتركها الدولة شاغرة، وهو عمل ضخم على أيّ حال؛ لكن تبقى نقطة النقاش هي تدخلها في السياسة؛ في نقاش جانبي جمعني مع الدكتور زياد عياري، الباحث والأكاديمي التونسي، حول ما هو الهياكل التنظيمي للحكم الأولي الإنتقالي في السودان، “What could be the organizational structure for an initial/ transitional government in Sudan” ناقش فيها دور المجتمع المدني في السياسة، وأشار إلى أن مشاركة المجتمع المدني في السياسة يعتبر سلاح ذو حدين، في حال عدم ضبطه وتنظيمه.جادلت في ذلك بالقوّل “أن مشاركة المجتمع المدني في السياسة أمرًا كارثيًا، نظراً للإختلافات الكبيرة بين منظمات المجتمع المدني، و المنظومات السياسية، فيما يتعلق بالواجبات. على مدى سنوات طويلة، وبفعل الحكومات الدكتاتورية، أصبح المجتمع المدني في السودان مسيساً للغاية؛ فمن الخطير السماح لها بممارسة السياسة، لقد ظهر ذلك بصورة جلية في الأزمة التي يعيشها السودان، حيث طغت أجندة المجتمع المدني على حساب القضايا الوطنية. بالإضافة إلى أنها قد ترتبط بأجندة المموليين “مما يجعل شروط عملها رهين بشروط الممول” وفي توصيف دقيق لهذا الشأن؛ أشار زعيم الحزب الشيوعي السوداني الراحل الأستاذ محمد إبراهيم نقد إلى هذه النقطة بقولة. (إنحرفت الكثير من منظمات المجتمع المدني عن أهدافها، وأصبحت ميدانًا لصراعات داخلية قائمة على أسس ذاتية وشخصية وهي خصومات لا ديمقراطية في أسبابها و وسائل إدارة الصراع، تميزت هذه المنظمات بصراع المكانة والوجاهة والإمتيازات المادية والمعنوية وغالبًا ما تتحول ديمقراطية هذه المنظمات إلى تحكم شلة نافذة تستولى على فائض القيمة المتمثل في المال والسفر والعلاقات العامة انها حضرية أو نخبوية، وهذا يعني أن العضوية محصورة وقليلة التأثير أولويات المموليين قد تؤثر على تحديد الأولويات الوطنية والمحلية)، وهو عين ما يحدث الآن في الساحة السودانية، ولقد ظهر بوضوح الدور السياسي لهذه المنظمات، وتأثيرها فاق تأثير الأحزاب السياسية، بل تقهقرت الأحزاب وتقدمتها المنظمات، الأمر الذي غيب الصوت السياسي، وأصبح الأمر برمته صراعًا متجهًا نحو المصالح، وضاعت معه القضايا الوطنية. من المعلوم أن كل منظومة لديها مشروعها السياسي والفكري الذي تحاول تنفيذه، وترى أن مشروعها دائما هو الافضل؛ لكن في العمل العام الفوز والنجاح حليف من يؤسس مشروعيته على العمل الداؤب عبر الإصلاح والترميم، وفق خطط وبرامج عمل واضحة، ليس فقط تصيد أخطاء الآخرين، ثم القوّل أننا طاهرون، هذا كسل لا يليق بقادة سياسيين يضعون أنفسهم أمام شعوبهم كما يُقال عندنا. درجت على المتابعة الراتبة لما يكتبه السياسي اليساري الأسباني بابلو اكليسياس، السكرتير العام لحزب “بوذا يموس”، أنقل لكم في نهاية هذا المقال مقتطف من بعض كتاباته حوّل مسؤولية القائد السياسي في التعامل مع الواقع، يقول إن السياسة غير مرتبطة بصدق ما تقوّل، وإنما هى مرتبطة بالواقع والنجاح الذي تحققه، قد تمتلك أفضل أدوات التحليل، وتفهم تاريخ التطور السياسي منذ القرن السادس عشر، وأن المادية التاريخية هي أساس فهم الصيرورات الإجتماعية، لكن ماذا يعني ذلك بدون فهم الواقع، عند دراسة حركات التغيير الإجتماعي الناجحة، سنلاحظ أن مفتاح نجاحها، هو خلق هوية توائم بين التحليل وبين ما تشعر به الأغلبية، وهذا أمر صعب، يتطلب منا مواجهة العديد من التناقضات. لا شك أن الكل في السودان اليوم ينظر إلى الأمام ربما يجد حلا يلوح في الأفق، وينهي هذه الحرب، بأىّ ثمن، وهنالك بالفعل من يعمل ويفكر ويكتب ويتحدث ويقاتل، كل حسب قدرته من أجل إنهاء الحرب، وإيجاد حلول مستدامة لمشاكل معقدة وتراكمات كبيرة من الأخطاء عبر عقود من الزمان؛ لكن المعالجات القاصرة والحلول المؤقتة عبارة عن تضييع لفرص وتبديد زمن، ثم لا يلبث أن يرجع الوضع إلى ما كان عليه و أسوء، بعد هذه المحنة يجب أن يتفق الجميع بعدم وجود جيش خارج المنظومة الأمنية للدولة السودانية، مع ضرورة إصلاح الممارسة السياسية، من قبل الأحزاب السياسية، وتطوير قدرتها تجاه المتطلبات الوطنية، سوف تنتهي الحرب لا محال؛ لكن يجب أن يكون ذلك لصالح بقاء الدولة السودانية؛ فهنالك حقيقية ينبغي أن يعلمها الجميع، هذا هو السودان والموجود فيه هو الشعب السوداني والمؤسسات هي مؤسسات الدولة، هذا هو الواقع الذي يجب أن نتعامل معه بواقعية.

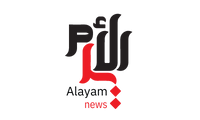

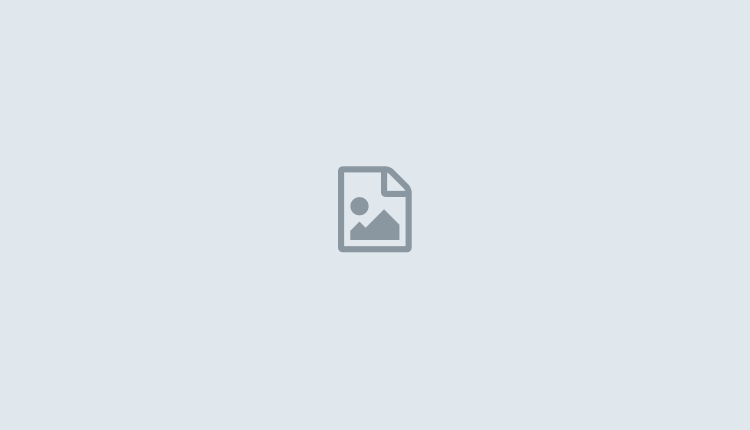

التعليقات مغلقة.