فرض عقوبات على السودان يعكس تعثرا في التصورات السياسية
العرب اللندنية – التشكيك في جدوى العقوبات التي اتخذتها واشنطن تجاه طرفي الصراع في السودان، لكونها خفيفة وتأثيرها محدود، ولخبرات النظام بوجهيه (الجيش وقوات الدعم السريع) بها، وقدرته على التعايش معها، أنها في النهاية، لن تحقق الكثير، وقد تسمح للطرفين بالرهان أكثر على الخيار العسكري بدلا من الحل السياسي.
ظلت الإدارة الأميركية مترددة في فرض عقوبات على الطرفين المتصارعين في السودان بعد اندلاع الحرب بينهما في منتصف أبريل الماضي، على أمل أن تفلح جهودها في حثهما على التهدئة ووقف إطلاق النار، والعودة إلى عملية سياسية تقضي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، لكن تصوراتها بدت بعيدة كثيرا عن الواقع الآن.
وتأكدت واشنطن من إصرار قائدي الجيش وقوات الدعم السريع على تغليب الحل العسكري، فأعلنت، الخميس، عن حزمة عقوبات مادية ومعنوية عليهما، لكن مشكوك في قدرتها على تحقيق ما أخفقت تحركاتها السياسية على إنجازه.
وكشف اللجوء إلى سلاح العقوبات الاقتصادية عن يأس وربما إحباط لدى الولايات المتحدة، وعجز في قدرة الوساطة التي شاركتها فيها المملكة العربية السعودية على تحقيق تقدم ملموس بعد مضي نحو شهر من استضافة جدة محادثات غير مباشرة بين وفدين من الجيش وقوات الدعم السريع، بغرض التوصل إلى اتفاق تهدئة لم يتحقق، وتجمدت الوساطة السعودية – الأميركية عقب إعلان وفد الجيش السوداني انسحابه منها.
عادت الولايات المتحدة لتوظيف أداة العقوبات الاقتصادية وهي تعلم أنها لن تحرز أهدافا سريعة، ما يجعلها تقتصر على الجوانب الرمزية وتوحي بأنها لا تزال قادرة على معاقبة من لا يطيعون أوامرها وعلى استعداد لتنويع أداوتها بين الجزرة والعصا.
وانتقد السيناتور الجمهوري جيم ريش الإدارة الأميركية على تويتر عقب الإعلان عنها، قائلا “إن العقوبات لا تمثل نصف خطوة تجاه ما يجب أن يحصل.. لا تحمّل كبار المسؤولين عن الوضع الكارثي في السودان مسؤولية ما يحصل”.
ويعد اللجوء إلى سلاح العقوبات هذه المرة أقل تأثيرا في السودان، فقد تعايش نظام الرئيس السابق عمر البشير مع العقوبات الأميركية نحو ثلاثة عقود، نجح خلالها في الصمود، بل شجّعته على إيجاد موارد وصناعات وروافد بديلة تقلل من النتائج التي استهدفتها واشنطن في عهد البشير، وأصبح السودان نموذجا حيا على إخفاق العقوبات الأميركية في القارة الأفريقية، ما يشي بأن اللجوء إليها بلا فاعلية كبيرة.
وتعني العودة إليها في غياب التأثيرات القوية في المرة السابقة أنها تريد تقويض حركة قوى أخرى تسعى لتمثل بديلا لها للانخراط في الأزمة وتفكيك عقدها، فالعقوبات يمكن أن تقلل من مساحة الحركة أمام أيّ من القوى المنافسة للتدخل عبر مقاربات سياسية جديدة، بما لا يساعد هذه القوى في القفز على الدور الأميركي الذي استخدم العصا في الظاهر لحث الطرفين على وقف الحرب، وفي الباطن لتأكيد أن واشنطن بإمكانها حرف مساراتها في السودان، إيجابا أو سلبا.
وتجاهلت الإدارة الأميركية ثلاثة من المحددات الرئيسية، الأول أن السودان يطل على سبع دول جوار، والحدود بين غالبيتها مفتوحة ويصعب السيطرة عليها أمنيا، وإذا كانت واشنطن أرادت من وراء فرض عقوبات على شركات أسلحة ومصادر تمويل مالي في الخارج، فثمة بدائل تتجلى في قنوات عديدة ويسيرة مع دول الجوار.
والمحدد الثاني، أن الجيش السوداني أنشأ قاعدة للصناعة العسكرية في الخرطوم وولايات أخرى خلال فترة العقوبات الأولى وأطلق عليها قبل الحرب “إمبراطورية الجيش الاقتصادية”، وقد تكون إمكانياتها محدودة غير أنها تنتج بعض أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وربما الثقيلة التي تساعد الجيش على الصمود وقتا أطول.
اقرأ أيضا:
والمحدد الثالث، عدم المفاجأة في مسألة العقوبات، فالجيش وقوات الدعم السريع استعدا مبكرا لها، وإذا كانت واشنطن تعتقد أنها تستطيع ليّ ذراعيهما عبر استهداف شخصيات معينة فهي مخطئة، لأن معظم استثمارات الجيش ليست بأسماء شخصيات عسكرية.
كما أن قوات الدعم السريع المعروف عنها غلبة البعد العائلي فيها من المؤكد أن زعيمها محمد حمدان دقلو (حميدتي) تصرف في الفترة الماضية بما لا يجعل هناك أموالا طائلة باسمه أو باسم قادة كبار من أقاربه، وجرى تفتيت شركات تأسست في دول خليجية للتجارة في الذهب والسلاح بما يصعّب عملية استهدافها بالمصادرة.
ويقول مراقبون إن فرض عقوبات اقتصادية هامشية لن يساعد الولايات المتحدة في السيطرة على مفاتيح الحرب، وربما يكون هذا التوجه إيذانا بالتعامل معها لفترة طويلة، وأن واشنطن باتت لديها قناعة أن فرص حث الطرفين المتصارعين للجلوس إلى طاولة المفاوضات تراجعت كثيرا، وأرادت تبنّي طريق يشبه إبراء الذمة.
ويضيف هؤلاء المراقبون أن إطالة الحرب تفضي للمزيد من الاستنزاف في القدرات المسلحة للطرفين وإجبارهما على البحث عن وسائل مختلفة للتغذية العسكرية الجديدة، ما يمكن أن يورّط بعض دول الجوار بمد الطرفين أو أحدهما بالأسلحة مباشرة، أو انتعاش سوق التهريب الذي كان رائجا في السودان من قبل.
في الحالتين، على المجتمع الدولي التعايش مع فصول غامضة في الحرب الدائرة أساسا في الخرطوم، وترقب انتقالها إلى مناطق أخرى، في مقدمتها إقليم دارفور، وأن كل طرف سيقوم بتدبير ما يحتاجه من معدات حسب متطلباته، فلن ينسى العالم أن حرب الإبادة الجماعية في دارفور استمرت نحو عشر سنوات، وسط تدخلات دولية متباينة، ولا تزال ذيولها مستمرة ويمكن أن يعاد تفجيرها في أيّ لحظة.
تكمن المشكلة في أن القوى الإقليمية والدولية عاجزة عن فك شفرة هذه الحرب، فمع تواصل التعامل مع الطرفين على قدم المساواة لن تكون هناك فرصة لممارسة ضغوط على أحدهما كي يستجيب للهدوء ويقوم بتليين موقفه العسكري، فالطرفان متمسكان بخطاب ينطلق من ضرورة اختفاء أحدهما، كما أن الفريق المنتصر لن يتخلى بسهولة عن السلطة، والتي سوف يعتبرها مكافأة طبيعية لتضحياته.
وتدعم هذه المسألة فرص إطالة أمد الحرب، مع وجود جهات تساند الطرفين وأخرى تساند طرفا على حساب الثاني، وهي المعادلة الخفية التي تفتح الباب للحاجة إلى المزيد من الوقت للتفكير في تهدئة جدية ووقف حقيقي لإطلاق النار يصمد في وجه العواصف التي يمكن أن تهبّ من أيّ جهة.
ولا تزال الحركات المسلحة تحافظ على حيادها المعلن من الطرفين، وقد ينزلق بعضها أو أحدها في الحرب لحساب طرف، لأن الهشاشة الطاغية على الأوضاع لن تصمد طويلا، ويمكن أن تختل مع اتساع الحرب وعدم اقتصارها على العاصمة الخرطوم.
وتؤكد العقوبات الاقتصادية أن الولايات المتحدة تفضل التعايش مع حرب طويلة على رؤية قائد عسكري قوي في السودان يمسك بتلابيب الحل والعقد، ولا يحافظ على مصالحها ولا تستطيع التعامل معه بسهولة أو ينحاز إلى روسيا والصين، خاصة أن الطرفين المتصارعين، الفريق أول عبدالفتاح البرهان والفريق أول حميدتي لديهما خطوط اتصال قوية مع موسكو وبكين، وأيضا واشنطن، لكن بنسب متفاوتة.

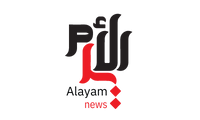



التعليقات مغلقة.