التعليق على الاتفاق النهائي للعملية السياسية
التعليق على الاتفاق النهائي للعملية السياسية
أي أطروحة بشرية قابلة للأخذ والرد، غير أن قمة نجاح السياسي في أن يتبنى مشروعه قواعده ويا حبذا منافسوه. بالعدم، وحتى إن لم يظاهرك المنافس، فلا تخوّنه أو تستفزه أو تحتقره فتنقلب المنافسة من شريفة إلى فاجرة. تظل هذه العبارات متقدة بالذات في ذاكرة الأوطان المكلومة التي لم يذق أبناؤها وبناتها نعيماً قط. هذه الورقة يطمح كاتبها في أن تجد طريقها للقائمين على العملية السياسية أو ما عُرف بالاتفاق الإطاري المستمد من مشروع الدستور الانتقالي. وتقديماً لهذه الورقة أقول أن الظرف التاريخي قد لا يسع لتناول معظم أوجه الوثيقة المطروحة، لذا قد يكون من الأفضل المرور على ما قد استوقف بعض ممن طرحوا عليّ تساؤلات جوهرية استلزمت التعليق. بوجه التحديد سأتناول هنا بعض جوانب النسخة المنشورة مؤخراً والتي استحدثت فقرات جديدة لم يسبق للكثيرين الوقوف أو التعليق عليها. مهما كان الموقف من النقاد والمحللين، فالأمل معقود في أن تبلغ وجهات النظر إلى العاكفين على صياغة الاتفاق السياسي وما سيضمنوه من بنود في الدستور الانتقالي:
أولا: التحفظات على منهجية الاتفاق الإطاري:
طالما قبل المجلس المركزي للحرية والتغيير أن يفاوض الانقلابيين فإن استبعاد أي قوى سياسية بخلاف المؤتمر الوطني المحلول لم تكن خطوة موفقة. فما طفح من تبريرات بخلق تفاضل بين أطراف الاتفاق السياسي على أساس الموقف من انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر فإن هذه الحجة ليست مقنعة لا من حيث المبدأ ولا الممارسة. فمن حيث المبدأ ليس بمقبول أن ترفض التفاوض مع انقلابي ثم تعود وتعفو عن مرتكب الفعل الأصلي متمسكاً بعقاب المحرض والمشارك جزئياً. أوضح دليل على التفاوت الموضوعي أن المصفوفة السياسية لم تنص على محاكمة من قاموا بالعملية الانقلابية ومعاقبتهم على جريمة تقويض الدستور بينما تمسكت بمعاقبة قوى سياسية أعلنت رفضها للإطاري. على صعيد الممارسة، نجد أن مركزي الحرية والتغيير اضطر للسعي للحصول على توقيع كل من رئيس الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) السيد جعفر الميرغني بجانب رئيس حركة تحرير السودان (مني مناوي) بالإضافة لرئيس حركة العدل والمساواة (جبريل إبراهيم). بالتالي، إذا قلنا أن الأخيرين هم من أطراف سلام جوبا فهناك حركات أخرى كانت إما جزء من ذات الاتفاق أو موقعة على اتفاقيات سلام ثنائية كالدوحة.
التفسير الوحيد لوجود اتفاقيات سرية مع الانقلابيين تضمنت تعريفاً بمن لهم حق العضوية في الاتفاق الإطاري، فإن هذا المسلك يكشف عن غياب الشفافية والرغبة في الانفراد بعملية سياسية محددة الأطر. بالطبع، وبحكم أن العسكريين لا مجال لتراجعهم من أي اتفاق إلا عبر حلفائهم الذين ظاهروهم في اعتصام القصر، فإن الخطأ الاستراتيجي والتكتيكي الذي وقعت فيه مركزية الحرية والتغيير كان التوقيع سراً مع شريك غير موثوق وعلى ورقة تتضمن الإقصاء من عملية سياسية في ظروف غاية في التعقيد. إذا لم يكتب النجاح للعملية السياسية فإن المكون العسكري يكون قد كسب جولة أخرى في إثبات قلة حيلة مركزي الحرية والتغيير. على أي حال، وعوداً لذي بدء نذكّر بأن نجاح أي عمل سياسي ليس في سيطرة من يصنعه بقدرما في قوة الجذب التي يتيحها للمعارضين فيتبنوا برنامجه ويمتلكوه.
ثانياً: تخوين المعارضين من قوى الثورة:
مما لا جدال حوله أن معظم السودانيين غير منتمين حزبياً ومع ذلك يمكن القول بأن كل القطاعات المنتمية وغير المنتمية شاركت وبفعالية في نجاح ثورة ديسمبر المجيدة. الاستفادة من هذا الواقع تطلب بأن توفي الأحزاب السياسية ما قطعت من وعد امام الثوار بألا يكونوا جزءاً من هياكل السلطة الانتقالية. يجدر بالذكر أن اعتصام القيادة وإن لم يكن هو شرارتها إلا أنه كان بمثابة المشكّل للقوى التي برزت أكثر تنظيماً لتقود ما بعد مرحلة الاعتصام. ليس بعيداً عن ساحات الاعتصام وما ترددت فيها من هتافات، وبحكم أن هناك سيطرة رأسمالية غربية على القرار السياسي العالمي فإن أي توجه يساند تلك الايدولوجيات فإنه لن يجد الدعم الإقليمي والدولي وذلك للرأي المحسوم سلفاً ضد معسكرات يمثلها أحزاب كالشيوعي السوداني. من الأسباب المأخوذة على هذا الحزب أنه رأى، ومنذ وقت مبكر، أن يستقل برؤيته رافضاً أي تحالفات، ولو مؤقتة، حتى تجاوز الفترة الانتقالية. مهما كان وجه الرأي أو الموقف من هذا الحزب أو غيره فإن المشروع الوطني يجب ألا يغفل أي حزب أو مواطن أو مجموعة من المواطنين وإنما يتعين أن استيعابهم أو على الأقل عدم معاداتهم أو تخوينهم بصورة تحاول أن ترضي الأجنبي على حساب أبناء وبنات الوطن.
لكون الأحزاب السياسية قررت أن تحكم خلال الفترة الانتقالية فكان أن برزت المنافسة بينها منذ صافرة البداية ولعل أصدق نموذج ما تجلى من خلافات تمخض عنها انشقاق تجمع المهنيين السودانيين. الرغبة في الوصول للحكم دون استحقاق انتخابي كانت وما زالت نقطة الضعف التي استغلها المكون العسكري مكشراً عن أنيابه ومتمسكاً بالسلطة التي لم يسلمها اصلاً. بالمقابل الاتفاق الإطاري الذي تم طرحه كحل سياسي سواء من حيث لغته أو طريقة تنفيذه كشف عن تبني “سلوك كل من ليس معنا فهو ضدنا”. بالطبع دخل في مسمى الضد وبالضرورة كل من فارقوا الحرية والتغيير مبكراً أو مؤخراً بمن فيهم كل من ينتقد أو حتى تأخر في المباركة.
ثالثاً: الملامح الدستورية والقانونية للاتفاق الإطاري:
بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر صدرت عن كل قوى الثورة عدد لا محدود من المواثيق والإعلانات السياسية والدستورية. هذه الموضة، وبكل أسف، لم يتوقف أثرها عند إضاعة زمن غال على الثورة والثوار وإنما أدت لأن تتمسك كل قوى بما أطلقت من رؤى. مهما يكن من أمر فإن مركزي الحرية والتغيير وبفكرة ودعم معلوم من المجتمع الدولي أطلق مشروع الدستور الانتقالي. بغض النظر عما وجدته هذه المرحلة من اتهامات وما أدت لمزيد الانشقاقات فإن الملفت للنظر التغيير المفاجئ في سلوك المكون العسكري حيث بدأ مستسلماً أو مجبراً على قبول العملية السياسية للدرجة التي وصفها حميدتي بأنهم ساروا فيها رجلهم فوق رقبتهم. النقطة الجديرة بالملاحظة هي زيادة الثقة لدي مركزي الحرية والتغيير بما تم فرضه من تعليمات للمكون العسكري للسير قدماً في العملية السياسية. هذه التعليمات تجلت بصورة مباشرة بعد زيارة مسؤولة ملف القرن الأفريقي في الإدارة الأمريكية (مولي في).
بحكم أنني سبق وأن علقت على الجوانب الدستورية والقانونية التي وردت في مشروع الدستور الانتقالي فسأكتفي هنا بالإحالة إليها منعاً للتكرار. للتذكير سنشير في هذا السياق لثلاثة أخطاء جوهرية في العملية السياسية وهي: الخطأ الأول: واضح أن الطمأنة والدعم من المجتمع الدولي والإقليمي أغرى مركزي الحرية والتغيير على الإمساك بكل أدوار ومراحل العملية السياسية. مركزي الحرية والتغيير أن يكرس التفاوض والتنظير علاوة على تفاصيل الكتابة والعمل الميداني والإعلامي بيد مجموعة محدودة من كوادره. هذه الطريقة أعادت للذاكرة المنهجية التي تمت بها أدارة حكومة حمدوك الثانية والتي عرفت بأحزاب أربعة طويلة والتي يجب أن تتحمل بسلوكها جزء من مسؤولية انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر.الخطأ الثاني : الدعم الإقليمي والدولي اللا محدود لم يفتح شهية مركزي الحرية والتغيير في حصر قيادة العملية السياسية على نفسه وحسب، وإنما المضي في تفصيلها على مقاسهم. مركزي الحرية والتغيير فات عليه أن يقرأ أن المجتمع الدولي لا يدعم مجاناً وإنما بسياسة لا تخلو من الاتفاق على الثمن الخطأ الثالث : الإصرار على إصدار مشروع دستور جامد يتضمن مجلس تشريعي انتقالي ومجالس تشريعية محلية بحجة الاستجابة لمطلب الشارع: الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب“. بلا جدال، أن اختزال سلطة الشعب في المجلس التشريعي قرار غير محسوب التفاصيل سواء من حيث العدة والعتاد. فهذه التفاصيل غير القابلة للتطبيق تعتبر من أكبر أسباب إضاعة الثورة في نسختها الاولى وستنعكس حتماً على فشل الاتفاق الإطاري لصعوبة تطبيق ما نص عليه من مسائل يستحيل إنجازها في فترة انتقالية لا تتجاوز العامين. بنظرنا المتواضع أن الأفضل أن يتم التوافق على مجلس تشريعي مهني في حدود 50 إلى 60 شخصاً يختارهم المهنيون من الكفاءات الوطنية غير المنتمية حزبياً. فتشريعات الانتقال التي تأتي بعد نظام أيدولوجي كالثلاثين من يونيو تحتاج لكفاءات استثنائية تملك القدرة على صناعة تشريعات تعالج وتؤسس لسودان جديد. هذا كله لا يتأتى إلا بموجب دستور انتقالي مرن كل صلاحياته في يد سلطة تشريعية محدودة على دراية بإصدار ما تتطلبه مرحلة الانتقال.
بالمرور على الاتفاق النهائي فأبرز وجه يمكن أن نسوقه لتاكيد ما ذكرنا من اختلالات هيكلية يمكن أن تؤدي إلى إجهاضه،في ظل وجود العوائق المعلومة، ما تجلى في الفصل الجديد المسمى الأحكام الختامية، والتي تقرأ: 1- أطراف الاتفاق السياسي هم:
(1)، (2) و (3) …
2- يُضمّن هذا الاتفاق في الدستور الانتقالي لسنة 2023 ويعتبر جزءاً منه.
3- اتفقت الأطراف على تكوين آلية للمتابعة والتقييم تكون (تتألف) من الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق على أن تُنظم اختصاصاتها واجتماعاتها بلائحة داخلية.
4- لا يجوز تعديل هذا الاتفاق فيما يتعلق بأي استحقاق وارد فيه إلا بموافقة صريحة وموقعة من الأطراف ذات الصلة.
5- ما لم يقتض السياق معنى آخر تعني جميع الإشارات لأطراف الاتفاق الإطاري أو الاتفاق السياسي، الأطراف المعرفة في المادة (1) من الأحكام الختامية.
6- في حالة وجود خلاف يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق تسعى الأطراف إلى حله ودياً عبر مشاورات قائمة على حسن النوايا تطلع ( تضطلع) بها لجنة المتابعة والتقييم المنصوص عليها في المادة (2).
المعلوم أن أي اتفاق سياسي يجب أن تُضمن بنوده وأحكامه فتتغير صفته من اتفاق لدستور او ما يقوم مقامه. الاتفاق السياسي وغيره من مفاوضات ما قبل تصبح ورقة دستورية تصلح أن تكون جزءاً من أدوات التفسير عند الخلاف أو لإزالة الغموض عن بنود الدستور إذا لم واضحاً ومعبراً بالقدر الكافي عن إرادة القوى التي صاغته. فالدستور، وبحكم أنه أعلى وثيقة تشريعية وأول مصادر التشريع لا يجوز أن توجد أي وثيقة أو آلية تعلو أو تسود على مؤسساته التقليدية المنشأة بموجبه. لا تعلو على الدستور حتى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية. الحال كذلك، وبحكم أن الدستور الانتقالي الذي أشار إليه الاتفاق النهائي قرر مبدأ قيام محكمة دستورية فإن سلطة تفسير الدستور وفض النزاعات تكون حصراً للجهات والمؤسسات التي قرر قيامها الدستور بحيث لا يجوز أن تكون هناك أكثر من جهة تفسر الدستور أو التشريعات بخلاف المحاكم المختصة.
كما أوضحنا، الاتفاق السياسي ليس إلا مرحلة تشرعن وجود السلطة التأسيسية غير أنه وباعتماد تلك القوى للدستور فإنه يصبح لا وجود لجان أو جهات بمجرد أن تفرغ حمولتها المحددة باختيار رأس الدولة أو رئيس الوزراء أو المجلس التشريعي. فإذا كان القصد من قيام لجنة المتابعة هو إعادة لمنظومة مجلس الشركاء كما كان عليه الحال في الوثيقة الدستورية لسنة 2019 فإن مشروع الدستور الانتقالي 2023 يختلف في هياكله عن وثيقة 2019. لذا فالواجب كان يقتضي النص بأن تُحل أي لجان مؤقتة بذات الطريقة التي ورد بها النص على حل المجلس العدلي بمجرد تسميته لرئيس القضاء والنائب العام وقضاة المحكمة الدستورية. بقاء النص والصبغة الدستورية للجنة واردة في الاتفاق السياسي سيجعلها تتحكم في المؤسسات الدستورية الطبيعية بما يكشف عن سلطة موازية تعطل الغرض الأساسي من وجود المؤسسات والهياكل الطبيعية وإلا ستكون هياكل صورية لا صلاحيات لها.
عند قراءة الاتفاق السياسي المتضمن لسلطة أو بالأصح لجنة متابعة في ظل وجود جهة تملك أن تعزل ممثلها في المجلس التشريعي أو أن ترشح بديلاً له بحجة عدم الالتزام بالاتفاق السياسي فإن هذه الثنائية ستكون أساس لأزمة دستورية في وقت كان الأوفق أن يترك الأمر لقانون المجلس التشريعي الذي يجب أن يحدد كيفية ملء ما يخلو من مقاعد عضويته طالما أنهم باتوا المؤتمنين على ما هو أكبر من مجرد إكمال خانة أو سد نقص في العضوية.
لا حل إلا بتوافق الموقعين أو من يجب أن يوقعوا الاتفاق السياسي على إعلان دستوري بسيط ومرن بحيث يتداعوا جميعا للخروج من العملية السياسية وأن يسندوا أمر الفترة الانتقالية لسلطة تشريعية من 50 – 60 من الكفاءات الوطنية المهنية غير المنتمية حزبياً فيختاروا من بينهم أو من خارجهم رأساً للدولة ورئيسا للوزراء بحيث يشكّل وزارته بذات مواصفات أعضاء المجلس التشريعي. ذات المجلس تُسند له تسمية رئيس القضاء ونوابه والنائب العام ومساعديه علاوة على قضاة المحكمة الدستورية والمفوضيات بما فيها مفوضية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالةالتمكين.
بحكم أن المجلس التشريعي سيتألف من كفاءات مهنية (مهندسين، أطباء، صيادلة، قانونيين، معلمين، زراعيين،، بياطرة، إداريين ونحوهم)، فتشكيل المجلس المهني سيضمن جودة تشريعات الانتقال والمفوضيات التي تحتاجها الفترة الانتقالية. محاولة حسم مشكلات تاريخية صاحبت نشأة
الدولة السودانية خلال الفترة الانتقالية يعتبر نوعاً من العبث الذي سيطيح بها كسابقاتها إذ يستحيل خلال سنتين فقطةالقدرة على حسم الموضوعات المزمنة. هذا السبيل كان الخطأ الجوهري الذي تضمنته الوثيقة الدستورية فكانت السبب المباشر لإفشال حكومتي حمدوك إبان الفترة الانتقالية في نسخة الثورة الأولى عندما كلفت نفسها ببرامج لا طاقة لها بها.
د. عبد العظيم حسن المحامي
3 أبريل 2023

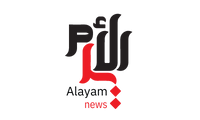



التعليقات مغلقة.