فريق شرطة “حقوقي” د. الطيب عبد الجليل حسين محمود يكتب جيش الضرورة وحرب الضرورة(9)
جيش الضرورة وحرب الضرورة(9)
(سايكولوجيا الحرب والعلاقات العسكرية المدنية)
أدبيات ونظريات سيكولوجيا الحربWar psychology بحسب مرئية الباحث في علم النفس الأستاذ/ ستيف تايلور Steve Taylorأستاذ علم النفس عبر الشخصية Transpersonal psychology والمحاضر في جامعة ليدز بيكيت في بريطانيا Leeds Beckett University LBU/UK، وكذلك التفسيرات النفسية للحرب التي طرحها ستيف تايلور في مقالة له عن أسباب الحرب الروسية الأوكرانيه من سؤال طرحه: لماذا يصعب على البشر أن يعيشوا في سلام؟ يجادل ستيف تايلور بأن الحروب دائماً ما تنشأ بسبب يعود لآثار نفسية إيجابية إرتداديه على الفرد أو المجتمع، بهدف التصدي لمهدد عنفي جماعي يقع أو يحدث من آخرين أفراد أو مجتمعات. ومؤداه، خلق شعور بالتكاتف والوحدة الوطنية في وجه التهديد الجماعي بتوحيد صفوف أفراد المجتمع، للتصدي للتهديد الجماعي الواقع من آخرين أفراد أو مجتمعات. وبالتالي، الانخراط في المعارك والقتال، لا يقتصر على الجيش فقط، بل يشاركه أفراد المجتمع كافة. فضلاً عن أن الحروب تجلب إحساساً بالإنضباط، والإمتثال وإحترام الأهداف الجماعية المشتركة، كما أن الحرب تعطي كافة المواطنين(وليس الجنود فحسب) حاسية شعور التصرف بشرف ومسئولية تلقائية وطوعية تجاه الوطن أرضاً وشعباً، والتخلي عن الأنانية الفردية من أجل خدمة الصالح العام. وأن الحرب على المستوى الفردي، تبعث في نفوس أفراد المجتمع شعوراً بأنهم على قيد الحياة، وأنهم يجب أن يكونوا على قيد الحياة. ولذلك، العقل الجمعي لأفراد المجتمع، يشتغل بإيجابية على أنهم أفراداً وجماعات، يجب أن يكونوا على أهبة الاستعداد، لمجابهة حالة العدوان الجماعي الواقع عليهم من آخرين أفراد أو جماعات. كما أن الحرب تمنح أفراد المجتمع هدفاً ومعنى، لتجاوز رتابة الحياة اليومية والتحرر من سطحيتها. وكذلك الحرب أيضاً تتيح لأفراد المجتمع فرصة التعبير عن القيم الإنسانية الجمعية المعتبرة، مثل الإنضباط والشجاعة والتضحية بالذات، والتي غالباً ما تكون متخفية في قلب دوامة الحياة العادية. وأن للحرب، عاملين مهمين:
- العامل الأول منها؛ هو الرغبة المؤججة في زيادة الثروة والمكانة والسلطة، وضم أراضي إقليم دولة بالإستيلاء عليها بدواعي تعزيز وتقوية الأمن القومي للدول. وكما أن الحرب غالبا ما تكون رغبة مجموعة واحدة من البشر – وعادة ما تكون الحكومات الحرب الروسية الأكرانية)، وأحيانا القبائل أو مجموعات عرقية(شتات عرقيات إثنية بدو الصحراء لدول غرب أفريقيا) – لرغبتها في زيادة قوتها وثروتها عن طريق غزو الأطراف الأخرى، وإخضاعها والاستيلاء على أراضيها ومواردها. ولذلك، معظم أسباب الحرب تتمحور حول الرغبة في ضم أراضٍ جديدة أو إستعمارها، أو السيطرة على المعادن الثمينة أو النفط، أو بناء إمبراطورية لزيادة الهيبة والثروة، أو الإنتقام لإهانة سابقة تسببت في التقليل من سلطة كيان/ دولة ما وهيبتها وثروتها.
- العامل الثاني الآخر في إثارة الحرب؛ هو إرتباط الحرب الوثيق بالهُوية الجماعية لأفراد المجتمع في الدوله بمعناها السياسي والقانوني، فالبشر عموماً تحركهم الحاجة القوية إلى الشعور بالإنتماء والهوية التي يمكن أن تتجلى بسهولة في النزعات العرقية أو القومية أو العقيدة الدينية. ووجود الحرب يشجع على التمسك أكثر بالهوية العرقية أو الهوية الوطنية الجمعية، ويزيد من الشعور بالفخر إزاء الجنسية الوطنية والإعتزاز بها، والفخر بالإنتماء إلى اللون والدين للإثنيات العرقية للجماعات المتعايشه في إيلاف جمعي في الدولة.
ومن ما يثير أدبيات الحرب والتقرير بشأنها – إعلان الحرب وأساليب كيفية التصدي لها ووقفها وإنهائها – تتبدى تجلياته من المناقشات والحوارات التي تدور حول قضايا وشئون الحرب والأمن في الدولة الحديثة والمعاصرة. لأن المناقشات والحوارات تثير أدبيات جدلية العلاقات المدنية العسكرية ما بين الجيش والأجهزة الأمنية، نظراً للجيش والأجهزة الأمنية كمؤسسات فاعلين لا دولة داخل النظام السياسى للدولة، وتفاعلها مع باقى المؤسسات المدنية الفاعلة في النظام والهيكل السياسي للدولة. ومصطلح العلاقات المدنية والعسكرية الشائع إستخدامه تعريفه وضبط معناه، أنها هي تلك العلاقات التي تكون بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية في الدولة، وحتمية هذه العلاقة أنها تهدف إلى تحقيق التعاون والتنسيق بين الجانبين المدني والعسكري لضمان الأمن والإستقرار في البلاد. والعلاقات العسكرية والمدنية تتضمن قضايا شئون الحرب والأمن في التخطيط الاستراتيجي للدفاع، وتوزيع الموارد، والتعاون في مجالات الأمن والدفاع. وغالباً عادة تشريعاً تقنيناً، يتم تحديد العلاقات المدنية العسكرية في الدستور أو في القوانين الوطنية للدولة.
وإزاء ذلك، المهتمون والمختصون بالشأن العسكري والأمني لدراسة العلاقات بين العسكريين والمدنيين وتفاعلها داخل مؤسسات الدولة، يجادلون بمرئيات تنظيريه، تناولت النظرية التقليدية المتعارف عليها بنظرية الجندي المحترف، وتحليلات هذه النظرية تفصل فصلاً تاماً بين العسكريين والمدنيين، وتبرر إخضاع العسكريين للمدنيين. إلا أنه لتجاوز سلبيات وإنتقادات النظرية التقليدية، ظهر في الأدبيات نظرية التوافق ونظرية أقتسام السلطه، وأدبيات كلاهما ردة فعل للأبعاد الثقافية، وأيضاً لمتغيرات التطور والتقدم السياسى والاقتصادى داخل المجتمع، ودرجة ومقدار الديمقراطيه التى يتمتع بها المجتمع، وكذلك مدى قوة المؤسسات الفاعله داخل النظام السياسي أو الإجتماعي.
ولإتسام الحروب الحديثه المعاصرة بدرجة عالية من التعقيدات العملياتية، نتيجة وسبباً لعامل التطور الكبير فى تكنولوجيا السلاح والحرب وقواعد الإشتباك (قانون الحرب والحياد)، وكإنعكاس تطبيقي لواقع العلاقات المدنية – العسكرية كما في الحالة الأمريكية، بعض الرأي طرح التنظير لفكرة المجمّع الصناعي العسكري Military industrial complex. وتقوم فكرة المجمّع الصناعي العسكري على التشبيك بين السلطة والإدارة والجيش والمجتمع المدني والمصانع، وإنشاء شبكات مصالح مترابطة مع هذه الأطراف، وإمتلاكها آليات التأثير على قرارات مختلف هذه الأطراف، مثل التأثير على وزارة الدفاع في قرارات إختيار الأسلحة، والتأثير على الإدارة السياسية في قرارات الحرب بإتخاذ قرار الحرب ووقفها وإنهائها، والتأثير على قرارات المجمع نفسه عبر إستقطاب الخبرات المدنية المهمة للإبتكار التقني والصناعي، وكذلك التأثير الإعلامي المرتبط بسياسات الدفاع والأمن. ولذلك، فقد سهلت كثيراً فكرة المجمع الصناعي على أن يكون للعسكريين الأضطلاع بأدوار إقتصادية وإجتماعية كبيرة لإدارة وتطوير فاعلية المؤسسات الإقتصادية لإنتاج مدخلات أدوات الحرب لتوفير السلاح والذخائر (كمثال في السودان وبحسب صفحة ويكيبيديا الموسوعة الحرة wikipedia، هيئة التصنيع الحربي Military Industry Corporation ومكوناتها منظومات الصناعات الدفاعية في مجمع اليرموك للصناعات المزدوجه، ومجمع الشجرة لصناعة الذخائر للأسلحة الصغيره، ومجمع الصناعات الثقيله في منطقة جياد الصناعية لصناعة الدروع والمدرعات والمركبات الثقيله، ومجمع الزرقاء الهندسي لصناعة مختلف الأجهزة الإلكترونية والكهربائية البصرية للجيش السوداني، ومجمع الصافات للطيران(ساك) لدعم القوات الجوية السودانية بأنواع طائرات المسيرات القتالية الهجومية لحفاظ قدرات الطيران العسكري السوداني). مما إستدعى ذلك في إستراتيجات العلاقة المدنية العسكرية إلى أن يكون هناك نوع من الدمج الوظيفي بين المدنيين والعسكريين في علاقة بعضهم ببعض في أو داخل الجهاز والتنظيم السياسي، بغرض توطين قدرات منظومات التسليح داخلياً، ولتقليل نفقات الصرف على معدات وأجهزة تقنيات الدفاع والأمن من موارد الخزينة العامة للدولة، ولفك عمليات إرتباط التسليح وتطوير القدرات القتالية والأمنية من الدول الخارجية الصناعية. وبإيجاز غير مخل، نشير لأدبيات التنظير في الآتي: - نظرية الجندى المحترف مؤسسياً: ويطلق عليها النظرية الكلاسيكية، وأساسها مستخلص من مفهموم الجيوش والأجهزة الأمنية المحترفة. وعملياً نموذج نظرية الإحتراف، تطبقة الولايات المتحدة الامريكية، بالنظر إلى أن المؤسسات العسكرية أجهزة فنيه تنفيذية، وأنها مؤسسات إستشارية للحكومة المدنية الديمقراطية. لإعتبارات الخبرة العملية للجندي أنها تكون فى مجال معرفى محدد، وممارسة تلك الخبرة عملياً فى إطار العمل المؤسسي للدولة في منظمة وظيفتها الأساسية هى إدارة العنف المعقلن، لإمتلاك منظمة الجندي لقوة الدولة. ولإعتبار أن الجندى المحترف خبير ممارس لعمله المحدد، وأنه يؤدى خدمات ضرورية وحاجية للمجتمع، لخدمة الأمن والحمايه لضمان فاعلية إستمرار المجتمع ككل. تأسيساً على إرتباط خبرة الجندي وإحترافيته بالعقلية العسكرية المتفردة، تدريباً وتأهيلاً لتأدية وظيفة خدمة الحماية والأمن للدولة وللمجتمع، وحيث العقلية العسكرية لخبرة وإحترافية الجندي هي الصورة الذاتية التعبيرية للعسكريين عن أنفسهم، وعن دورهم الوظيفي في المجتمع، وأن ذكاء العقلية العسكرية هي الصورة المميزة للعسكريين عن المدنيين. وبذلك العسكريين والمدنيين يشكلون جماعتين مختلفتين، وأن هناك تمايزات فرعية بين كل منهم. ومؤداه الآتي:
(1) إخضاع العسكريين للمدنيين داخل النظام السياسي للدولة؛ و،
(2) الفصل التام بين العسكريين والمدنيين؛ و،
(3) إحتكار المدنيين لإدارة جهاز الدولة (السلطة والحكومة)، لإحتكار المدنيين إدارة الصراعات السياسية (الأحزاب السياسية والإنتخابات)، دونما إعتبار لمكانة العسكريين داخل النظام والهيكل السياسي للدولة، رغماً عن أن العسكريين أحد الفاعلين دون الدولة داخل الهيكل السياسى للدولة. - نظرية التوافق، وأساس النظرية يتناول مسألة خضوع السياسة الخارجية للإعتبارات والمؤثرات الداخلية، وأنها تتناول أهمية الفصل بين الإعتبارات الأيديولوجية وبين القرارات التي يجب إتخاذها لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي. ولذلك، فإن النظرية تبرر وتؤكد على أهمية التعاون بين العسكريين والمؤسسات السياسية والمجتمع ككل، لأن العسكريين والقيادة السياسية والمواطنين فيما بينهم جميعاً، وقت الحاجة والضرورة شركاء في منظومات العمليات العسكرية والأمنية، لإعتبارات المسئولية الجمعية عن الأمن، تبعاً على أن الأمن مسئولية الجميع. وأنه عندما يكون هناك إتفاق بين العسكريين والمدنيين والمواطنيين بشأن طبيعة دور العسكريين في السلطة، فإن ذلك يقلل من إحتمالات تدخل العسكريين في السلطة. لإعتبارات تبريرات المنظرين للنظرية أنها تأخذ في الحسبان الظروف والمتغيرات الثقافية السائدة، وكما أنها تحمل قدرة تنبؤية حول إحتمالات تدخل العسكريين في السلطة. وأن النظرية صالحة للتطبيق في النظم التي لا يوجد لديها ميراث أو تاريخ سياسي مؤسسي معتبر، لكيما تؤكد على القيم المتعلقة بالفصل بين العسكريين والمدنيين. وأن النظرية على حد سواء، تصلح للتطبيق فى النظم الديموقراطية، وفي النظم السياسية حديثة التحول نحو الديموقراطية. ومشيرةً النظرية في تحليلاتها إلى أهمية عدم السماح للمؤسسة العسكرية بالتدخل بشكل كبير في الشأن الداخلي، ولكن مع عدم إنكار أن الجيش معني بالسياسة. ولذلك، هناك حاجة لتحقيق التوازن والتوافق بين العسكريين والمدنيين، لإعتبار معايير أربعة حددتها النظرية، ونشير لها في الآتي:
(1) معيار التكوين الاجتماعى للضباط وصف الضباط والجنود، نظراً لعلم الاجتماع العسكري، بأن أفراد المؤسسة العسكرية يمثلون معظم هيئات الأمة والشعب وفئاتها. وبالتالي، العلاقة العسكرية المدنية ليست فقط بين السلطة والجيش والأجهزة الأمنية، بل ينبغي أن تكون علاقة ثلاثية، بإدخال المجتمع في المعادلة، نظراً لمحورية وأهمية الإسهام المدني في العلاقة مع المؤسسة العسكرية، مثل إختراع باحثين وخبراء مدنيين للقنبلة النووية، فضلًا عن تغذية المجتمع الجيش بالمجندين من الضباط وصف الضباط والجنود، باعتبارهم مدنيين قبل الإنضمام للجيش، ولحتمية عودتهم إلى الصفة المدنية بعد إنتهاء مدة خدمتهم العسكرية أو الأمنية.
(2) معيار عملية صنع القرارات السياسية، لإختصاص العسكريين ببعض القرارات الهامة المرتبطة بطبيعة ونوع العمل العسكري أو العمل الأمني، مثل وضع الترتيبات المتعلقة بقيام الحرب وإنهائها ووقفها، وتحديد أساليب التصدي للمهددات الأمنية. وتحديد الميزانية التشغيلية للعمليات العسكرية أو الأمنية. وتحديد الحوافز المالية للأفراد، من مرتبات وأجور وعلاوات وبدلات ومخصصات وفوائد ما بعد الخدمة. وتحديد حجم وعدد القوة البشرية(الموارد البشرية HR)، من الضباط وصف الضباط والجنود. وتحديد مواصفات ونوعية وأماكن مقار الأبنية العقارية للثكنات(مقار الثكنات الإدارية ومواعين التدريب والتأهيل، والمقار السكنية. لإعتبار العسكريون عادة ما يقوموا بتحديد إحتياجاتهم، والتعبير عنها من خلال القنوات الحكومية.
(3) معيار طرق التجنيد للخدمة العسكرية والأمنية، وهو شق متعلق بالتعين في الخدمة والترقي في الرتب العسكرية والأمنية، بدءاً من مداخيل الخدمة من حيث المساواة ومؤهلات القدرات والكفاءة عند التقديم للخدمة والترقي دون تمييز أو محاباة، إلا بقدر معيار الكفاءة والمؤهلات. ولأن أساليب التجنيد والإستمرار في الخدمة، عادة قائمة على الإقناع، لا على القهر والإجبار.
(4) معيار نمط المؤسسة العسكرية، نظراً لها من العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمواطنين والنظام السياسي السائد. ونمط المؤسسة العسكرية عادة ما يشير إلى الشكل الخارجى للمؤسسة العسكرية والبنية الداخلية والعلاقة بينهم. وذلك لأن نمط المؤسسة العسكرية هو المرآة التي خلالها تنعكس العوامل الثقافية والتاريخية والإنسانية للمؤسسة العسكرية، وذلك من حيث كيف تبدو المؤسسة العسكرية في نظر المواطن وفي نظر منسوبيها؟ وماهى القيم الثقافية الكلية السائدة في المؤسسة العسكرية؟ وكيف المواطنون يرون المؤسسة العسكرية؟ وهل القيم السائده في المؤسسة العسكرية تعبير وإنعكاس للقيم الإجتماعية والثقافية الكلية السائدة في المجتمع؟ - نظرية اقتسام السلطة، أو النظرية التكاملية/ نظرية التكامل؛ وأساس النظرية يقوم على أن للعسكريين دورهم فى مجالات الدفاع والأمن والحماية بشكل أساسى في الحالات العادية، وإلى جانب دورهم فى حفظ الأمن الداخلى وقت الضرورة والحاجة . وعلى مستوى التحليل للنظريه، فهي تدعم سيطرة المدنيين على المؤسسة العسكرية، لإعتبارات نماذج سوقت لها النظرية، تأسيساً على مهمة المؤسسة العسكرية، قولاً بأن المؤسسة العسكرية التى تواجه تهديداً خارجياً، لن تمثل تهديداً داخلياً. وأن وجود نظام مؤسسي مدني فعال، مؤداه، أنه يعمل على وجود قياده مدنيه قويه داخل المؤسسات السياسية للدولة، وبالتالي، يمكن لهذه القيادة المدنية تحقيق السيطره على العسكريين. والقول بحالة إفتراض السمو المدني على العسكري، بإفتراض أن السيطرة المدنية على العسكريين، يتطلب تدخل القادة والسياسين المدنيين بشكل نشط وفاعل وعلى كل مستويات النظام والهيكل السياسي للدولة، تأسيساً على مدنية الدولة والسلطة. والقول بإنسانية العلاقة العسكرية المدنية، بإفتراض وجود إطار عام يخلو نسبياً من عدم الثقة والتوتر بين العسكريين والمدنيين، ويحقق درجة أعلى من التنسيق بينهم. وأساس توافر الثقة بين العسكريين والمدنيين، يقوم على مدى درجة الفعالية العسكرية في التخطيط والدفاع العسكري، بمشاركة المدنيين مع العسكريين في التقييم لسياسات الدفاع والأمن، والتقييم المشترك لمعايير الأمن القومي، والشراكة المدنية مع العسكريين في التقييم لدور أجهزة الإستخبارات والمخابرات. والعمل سوياً على إيجاد درجة فاعلة من المرونة والتفاعل المؤسسي بشكل أكبر، لتحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز الأمن والحماية وفقاً لإعتبارت الأمن القومي للدولة. ولذلك، النظرية تقوم على إفتراضين رئيسيين، ونشير لها على النحو الآتي:
- الأفتراض الأول: السيطرة المدنية على العسكريين محققة ومستمرة من خلال إقتسام السلطة، لأن لكل من المدنيين والعسكريين مسئولياته المحددة والمرسومة تجاه جوانب معينة، ويتم المحاسبة عليها، ولذلك لا يكون هناك تداخل بين المسئوليات.
- الأفتراض الثاني: وهو أنه هناك مصدراً وحيداً وشرعياً لتوجيه العسكريين وإخضاعهم للمدنيين، ومشروعيته نابع من المدنيين المنتخبين من خارج المؤسسة العسكرية. وبالتالي، إخضاع العسكريين للمدنيين عملية متغيرة وديناميكية، تتغير وفقا للأفكار والقيم والظروف المحيطة، وتتغير وفقاً للقضايا والمسئوليات والضغوط المرتبطة بالأزمات والحروب.
وبحسب النظرية، لايوجد تعارض بين إقتسام المسئولية والسيطرة المدنية لإخضاع العسكريين للمدنيين، لأن إقتسام السلطة بين العسكريين والمدنيين، يرجع إلى أنهما يتشاركان فى إتخاذ القرارات فى عدد من جملة قضايا، وعلى سبيل المثال أهمها : القضايا الإستراتيجية التي تتضمن مجموعة من القرارات المتعلقة بأليات الدفاع والأمن وقدراتهما. وأيضاً القضايا التنظيمية التي تتعلق بالمؤسسة العسكرية والمجتمع. وكذلك القضايا العملية المتعلقه بإستخدام المؤسسة العسكرية في الحرب وفي عمليات الأمن الداخلي .ورغماً عن ذلك، العلاقات المدنيه العسكريه تواجه عدة معضلات، وعلى سبيل المثال نشير لمعضلة تنامي قوه العسكريين داخل النظام السياسي (البرويتوريه)، والمعالجة، يلزم ضروره الحد من قوه العسكريين داخل النظام السياسي. ويثير البعض معضلة الحفاظ على قوه مسلحة منظمه وقويه دون حاجة لها، ودون أن يكون هنالك تهديداً للمجتمع .وأيضاً معضلة إستغلال القوى السياسيه المدنية لنفوذها لإحتكارها سلطة الدولة، وسعيها إلى زياده قوتها من خلال المؤسسة العسكرية(إستعانة الأحزاب السياسية بالمؤسسة العسكرية لتغيير أو الإنقلاب على نظام الحكم). وكذلك معضلة التوفيق بين الخبير والإستشاري والوزير السياسي المدني، لأنه عادة يفتقد الوزير المدنى للخبره والدراية بالأمور العسكريه والأمنية.
ولكن على الرغم من ذلك، النظرية تصلح ويجوز تطبيقها على الدول الديموقراطية والمدنية السلطة والحكم، وأيضاً يمكن ويجوز تطبيقها على الدول حديثة التحول والإنتقال المدني نحو الديموقراطية. لأن العسكريين عادة لهم دورهم الفاعل فى صنع القرارات المتعلقة بالقضايا الدفاعية والأمنية، ومختصين في صنع قرارات كيفية إستخدام وتوظيف المؤسسة العسكرية فى ظل السيطرة المدنية على مقاليد الحكم والسلطة. وللحديث بقيه، ونترك لها مساحة حديث مناسبة أخرى.
فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
(المحامي)
12 /10 /2023م

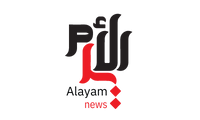


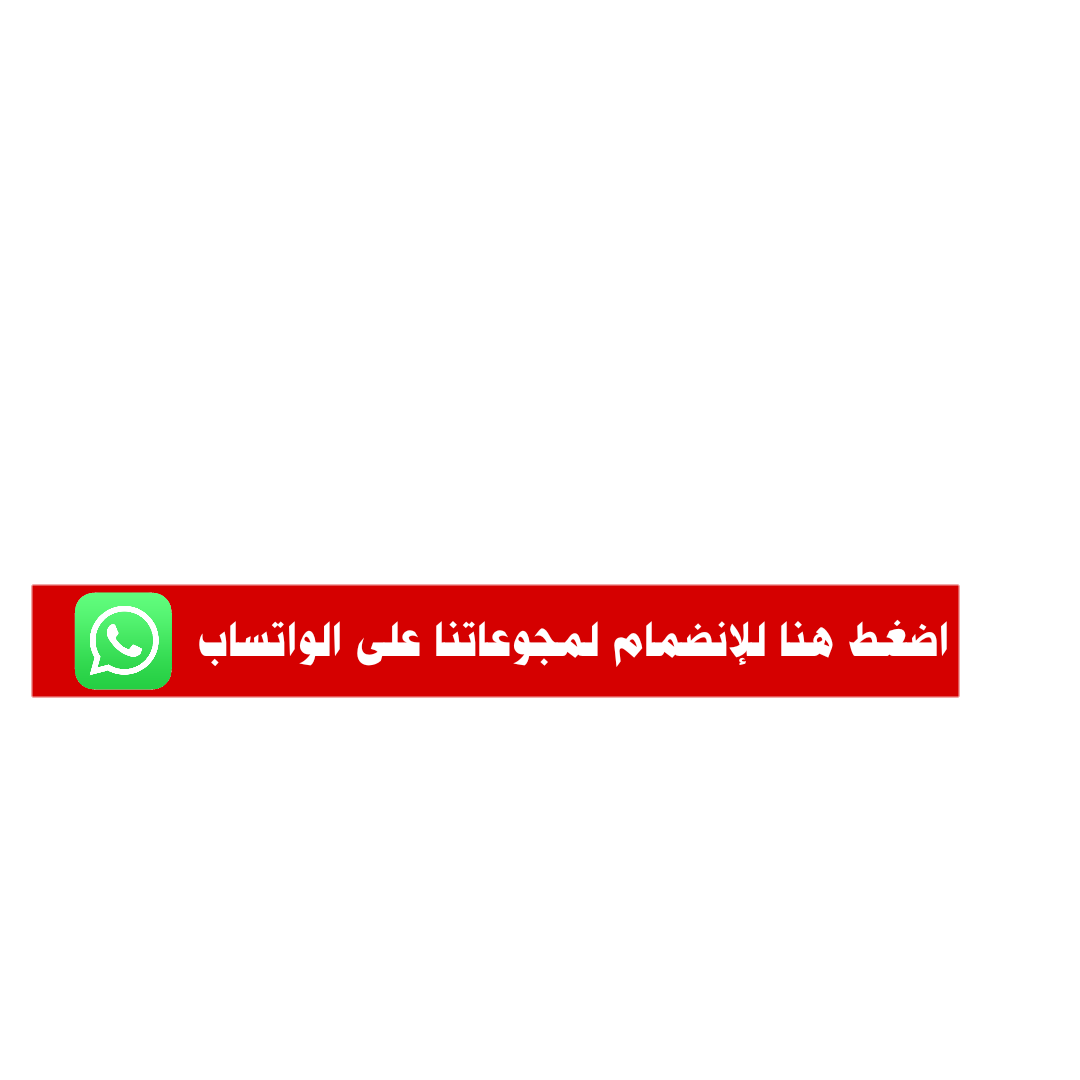
التعليقات مغلقة.