مشاهد محمد الطيب عابدين بحث حول مفاهيم ( الأمية النبوية )
الخرطوم : الايام نيوز
بسم الله الرحمن الرحيم
*مشاهد**محمد الطيب عابدين* *بحث حول مفاهيم ( الأمية النبوية )*
ورد في معجم *المصباح المنير للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ ، مكتبة لبنان سنة ١٩٨٧م، صفحة “٩” : { … و الأمة أتباع النبي و الجمع أمم … و تطلق الأمة على عالم دهره المنفرد بعلمه ، و الأمي في كلام العرب الذي لا يحسن الكتابة فقيل نسبة إلى الأم لأن الكتابة مكتسبة فهو على ما ولدته أمه من الجهل بالكتابة ، و قيل نسبة إلى أمة العرب لأنه كان أكثرهم أميين …* } و في ذلك يقول البروفيسور *جعفر ميرغني في تعريفه لمعنى الأمي : (( النبي الأمي هو المرسل إلى الأمم كافة وليس إلى بني إسرائيل وحدهم كبقية أنبياءهم* )) و يتسائل جعفر ميرغني : (( *لماذا كتب في القرأن الكريم : { ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ }* الأية (1) سورة القلم لماذا كتبت ” *ن*” حرفاً واحداً ، بينما كتبت في إسم *ذو النون ” ن و ن ” ولم تكتب مثل الأولى حرفاً واحداً ؟ : { وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين }* الآية ٨٧ سورة الأنبياء و في تبريره لذلك أنها كتبت تحت نظر الرسول صلى الله عليه وسلم، و أنه كان يكتب و يعرف الحرف لذا و جه الكُتاب بذلك الفرق في الخط بين “ن” و “ذو النون ” . )) إلا أنني أرى أن أمين الوحي جبريل كان يُعلم النبي القرآن و يحدد له مكان الآيات من السور و شكل الحرف إن كان “ن” أو “نون” لان النبي الكريم لم يكن يخط الحرف بيده ولا يقرأ الرسوم كما سيأتي بيانه لاحقاً ، وهذا *لا يعني صحة معنى الامي المتداولة بالجهل و عدم المعرفة بالقراءة و الخط، و في كلٍ تفصيل لاحق* . و يضيف بروفيسور جعفر ميرغني في محاضرته العلمية الرائعة : (( *أن كتابة المصاحف في زمن عثمان بن عفان ، و زيد بن ثابت وهو يكتب، كان لا يكتب آية إلا أن يشهد عليها صحابيان أنهما أخذاها من الرسول مباشرة، و زيد كان حافظاً للقرآن عن ظهر قلب ولكنه الحرص و التثبت ، و قال زيد بن ثابت أنه تتبع القرآن في الألواح و السعف و الكتوف ، ما يعني أنه جمع كل الوثائق الموجوده و وضعها أمامه ، إلا أنه لا يلتفت إلى مخطوطة حتى يشهد صحابيان انها كتبت زمن الرسول ، وهذه الطريقة هي المتبعة حتى الآن في تحقيق الوثائق ، أي جمع كل النسخ من المخطوط المراد تحقيقه* . *و حدث عبد الله بن مسعود أنه جاء إليه رجلان يطلبان سورة الشعراء ، فقال لهم هي ليست معي ولكن عليكم بمن أخذها عن رسول الله ( فلان ) بمعنى ليست معي مكتوبة ، و كان هو ، عبد الله بن مسعود ، حافظاً للقرآن عن ظهر قلب ولكنه ارسلهم لمن كتبت عنده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم* . )) “راجع حديث بروفيسور جعفر ميرغني في محاضرة منشورة في مقطع فيديو ” . ومن حديث بروفيسور جعفر ميرغني *نخرج بالأتي* : ١/ ثبت معرفة الرسول بالكتابة و القراءة ، *و ان كان في ذلك نظر* . ٢/ حدد معنى *”الأمي”* بأنه الرسول المرسل للأمم كافة ، أي نسب كلمة *”الأمي”* إلى *”الأمة”* و جمعها *”أمم”* ، وليس بمعني من يجهل الخط و القراءة . ٣/ أثبت أن الكتابة و القراءة كانت معروفة و موجودة زمن النبي و ان أمة محمد ليست أمة جاهلة لا تكتب ولا تحسب كما يدعي البعض . ٤/ أصل لمنهج البحث العلمي في تحقيق المخطوطات بضرورة جمع كافة نسخها و وضعها أمام الباحث المحقق للنظر فيها بغية تحقيقها . ٥/ أكد حرص الصحابة ، كتبة القرآن الكريم ، في ضرورة شهادة صحابيين على كل سورة قبل كتابتها حتى و ان كان الكاتب يحفظ القرآن عن ظهر قلب ، وهو أمر قد ذكره و أكده الله تعالى أنه حافظ لهذا القرآن من التحريف و التبديل . و من ناحية أخرى أورد الفيلسوف المفكر السوداني محمد أبو القاسم حاج حمد في المجلد الأول من كتابه الموسوم { *العالمية الإسلامية الثانية* } صفحة ١٥٣ و ما بعدها ؛ قوله : (( … *أن “الأمي” هو غير الكتابي ، أي غير المسيحي أو اليهودي، و ليس غير الكاتب* … حين يقال ( النبي الأمي ) بما يعني أنه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الرسوم و لا يخط بيمينه، ثم نقول أن الأمية لا تعني ” *غير الكاتب*” و لكنها تعني ” *غير الكتابي*” ، ينصرف فهم الناس بأننا نثبت للرسول حالة كونه كاتباً و قارئاً للرسوم . و هذا *فهم خاطئ و قائم على خطأ مركب في شيوع اللسان العربي . فالنبي لا يقرأ الرسوم و لا يكتب ، ولكن ليس بمعنى “أمي” و لكن بالمعنى الذي أورده القرآن: { وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ }* الآية (48) سورة العنكبوت . (( فالنبي “غير كاتب” لأنه لا يخط بيمينه ، وهذه مسألة قطعية واضحة، و هذا المعنى لا علاقة له بالأمية قطعاً و جزماً ، *فالأمية تعني أنه غير كتابي و ليس غير كاتب* . و كذلك العرب *( أميون – غير كتابيين )* لم يتداولوا الإيمان بالكتب السماوية بينهم، ولكنهم يكتبون و يخطون بيمينهم، وليست جاهليتهم بمعنى عدم المعرفة بالقراءة و الخط و لكنها جاهلية حمية و تفلت من قيود العقل . (( … ان القرآن لا يشير إلى تلك الحقبة السابقة على الإسلام بوصفها *جاهلية و إنما بوصفها ( أمية )*، و ذلك حين يتجه الخطاب القرآني للمقابلة بين من سبق أن تنزل عليهم الكتاب، و هم اليهود ، و بين الذين لم يتنزل عليهم كتاب وهم الأميون و ليس الجاهليين: *{ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ }* [آل عمران: الآية ٢٠]. (( ثم في سورة “الجمعة” يحدد الله – سبحانه – فئتين من الأميين ( غير الكتابيين )، فئة تنزل عليها القرآن و انبعث النبي الأمي من بينها ، ثم فئة أخرى لم تلحق بالفئة الأولى بعد و لكنها لاحقة ، ثم يقابل الله بين فئتي الأميين و الكتابيين اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها . *{ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ }* سورة الجمعة من الآية ٢ – ٥ (( و تعميقاً لهذه *الدلالة اللغوية المعرفية في لسان القرآن نجد أن الله – سبحانه – يطلق على الفئات الضالة من اليهود* الذين يكتبون و يقرأون صفة ( *أميين* ) لتقرير أنهم لا يفهمون التوراة و يزيفون معانيها و يدسون عليها من كتاباتهم : *{ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ * فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم و ويل لهم مما يكسبون }* سورة البقرة الآية (٧٨ – ٧٩ ) . فهؤلاء الأميون اليهود يكتبون – يكتبون الكتاب بأيديهم – و – فويل لهم مما كتبت أيديهم ، *فهم أميون لأنهم ( لا يعلمون الكتاب إلا أماني و إن هم إلا يظنون ) . فصفة الأمي تنطبق على من يجهل كتابه و يأخذه بالظن و الأماني وليس الأمي من يجهل الكتابة* . بل إن *اليهود يميزون بين أنفسهم أهل كتاب ( التوراة ) و بين سائر الشعوب الأمية الأخرى* ، فستعلوا عليها و استباحوا أموالها :*{ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍۢ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍۢ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِى ٱلْأُمِّيِّنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ }* سورة آل عمران الآية ٧٥ (( قد أشكلت هذه المعاني على كثير من المفسرين، و جنح الفكر السائد ، دينياً أو أدبياً إلى إطلاق *صفة أمي على غير الكاتبين، فدرج الناس على تعريف الكتاتيب حيث يتعلم الأطفال أو الكبار بمدارس ( محو الأمية )، و محو الأمية تعني محو الإيمان بكتاب الله و تصديقه ، فالأولى بنا أن نعرف هذه المدارس بأنها ( مدارس تعليم الخط و الكتابة* ) و ليس محو الأمية . (( قد وثق السائد من ” *لسان العرب* ” هذا المعنى المغلوط للأمية ، و لتأكيد هذا التوثيق نسبت أقوال إلى الرسول لم يقلها مثل : *( إنا أمة أمية لا نكتب و لا نحسب )*، *فكيف كُتب الوحي القرآني و هم لا يكتبون ؟ ، و كيف كتبت المعلقات الشعرية و علقت في الكعبة وهم لا يكتبون ؟، و كيف حسبوا تجارة الصيف و الشتاء و هم لا يحسبون؟، و من أين جاءت و كيف تطورت الأبجدية العربية وهم لا يخُطون ؟، و بأي خط كتب الرسول رسائله إلى عظماء الروم و الفرس ؟، و بأي خط صيغت صحيفة المدينة ؟، و بأي خط كتبت معاهدة الحديبية ؟، و الرسائل إلى ولاة الأمصار و مناطق الثغور* ؟ . (( مع ذلك وثقت معظم مراجع اللغة العربية هذا الخلط ، فجعلت الأمي هو ( *غير الكاتب* ) و ليس ( *غير الكتابي*)، و مثالاً على ذلك نورد النص التالي من ( لسان العرب لابن منظور ) : (( و الأمي : *الذي لا يكتب، قال الزجاج : الأمي الذي على خلقة الأمة لم يتعلم الكتاب فهو على جبلته ، و في التنزيل العزيز : و منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ، قال أبو إسحاق : معنى الأمي المنسوب إلى ما عليه جبلته أمه أي لا يكتب ، فهو في أنه لا يكتب أمي ، لأن الكتابة هي مكتسبة فكأنه نسب إلى ما يولد عليه أي على ما ولدته أمه عليه ، و كانت الكتابة في العرب في أهل الطائف تعلموها من رجل من أهل الحيرة ، و أخذها أهل الحيرة عن أهل الأنبار . و في الحديث : إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ، أراد أنهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة و الحساب ، فهم على جبلتهم الأولى . و في الحديث : بعثت إلى أمة أمية ، قيل للعرب الأميون لان الكتابة كانت فيهم عزيزة او عديمة ، و منه قوله بعث في الأميين رسولاً منهم . و الأمي ” العي الجلف الجافي القليل الكلام* ” . )) “راجع المحيط للعلامة ابن متظور – لسان العرب – إعداد و تصنيف يوسف خياط – دار لسان العرب – بيروت – ص ١٠٥ ” . *ماذا عن الكتابة في جزيرة العرب؟* “””””””””””””””””””””””””””” هناك لغات عديدة كان لها حروف للكتابة خاصة بها مثل الدادانية و الثمودية. و لكن الحروف المكتوبة *(أو ما يُعرف بالخط أو القلم) الأكثر انتشارا في الجزيرة العربية كان المسند أو السبئي في الجنوب، و الأرامي النبطي في الشمال*. ثم دخل إلى الشمال الكتابة اللاتينية و اليونانية بعد دخول الرومان. فيما عدا ذلك، كل الخطوط أو الأقلام الأخرى كانت للاستخدام المحليلم يكن للغة العربية خطاً خاصاً بها – ربما لأنها لم تكن بأهمية المسند أو النبطي أو اللاتيني أو اليوناني – ربما لأن عدد الناس المتكلمين بها كان محدودا – ربما لم يكن هناك حاجة لخط خاص بالعربية إذا كان من الممكن اسنخدام حروف لغات أخرى لكتابة كلمات عربية حيث أن الإنسان يلجأ للتدوين بلغة معينة عندما تصبح حيوية للاستعمال في الشؤون الإدارية. لا أحد يعرف على وجه التحديد لماذا تأخر تطوير الحروف العربية – و لكن ما نعرفه على وجه التأكيد هو الآتي:*أولاً* : أن اللغة العربية المنطوقة كانت مستخدمة في القرن الثاني الميلادي بدون كتابة. هذا يعني أن النطق بها قد ظهر قبل هذا بقليل. و الدليل على هذا هو أن أول ظهور للكلمات العربية المكتوبة كان في أوائل القرن الثاني الميلادي، كانت كلمات مكتوبة بالخط الأرامي النبطي في منطقة مملكة الأنباط. و لا يوجد ذكر لأي كلمة عربية قبل هذا النص حتى لو مكتوبة بحروف غير عربية*ثانياً*: حدث تحول أو انتقال تدريجي في الحروف النبطية لتصبح حروف عربية فيما بين القرنين الثالث و الخامس الميلادي*ثالثاً*: أول ظهور للكتابة العربية *كان في أوائل القرن السادس الميلادي* – و كانت عبارة عن حروف مشتقة من الحروف النبطية. و تطورت هذه الحروف فيما بعد لتشكل ما يُعرف بالخط الحجازي و الذي انتشرفي وسط الجزيرة العربية. و لم يكن الخط الحجازي في البداية منقطا و لم تكن هناك همزات – و قد أضيفت هذه العلامات في وقت لاحق. و عندما دخلت العراق في نطاق الدولة الإسلامية، تطور الخط الحجازي إلى الخط الكوفي . و في إطار بحثه القيم حول ( *الأبجدية – نشأة الكتابة و أشكالها عند الشعوب* ) يوضح *الدكتور أحمد هبو* أن الكتابة العربية قد تكونت بين القرنين الثالث و السادس الميلاديين ، و أنها كانت معروفة في الحجاز و الحيرة في منتصف القرن السادس الميلادي، لذلك لم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم صعوبة كبيرة في تثبيت ما يوحى إليه كتابة من آيات القرآن الكريم، و في الوقت الذي يلي الوحي مباشرة ، إذ كان الصحابة يسجلون ما يمليه عليهم . “راجع : د. أحمد هبو – الأبجدية – نشأة الكتابة و أشكالها عند الشعوب – دار الحوار للنشر و التوزيع – سورية – اللاذقية – الطبعة الأولى ١٩٨٤م – ص ٨٦ – ٨٨ ” . (( و كما أن الكثير من القواميس العربية المعتمدة لم تدقق في أصول و دلالات هذه الألفاظ، كذلك يضطرب الإخباريون العرب الذين بدأوا مهماتهم التدوينية في عصر متأخر بثلاثة قرون عن ظهور الإسلام ، و في هذا الإطار يوضح لنا الدكتور *حسين مروة شكلاً من أشكال هذا الأضطراب : ” من الثابت تاريخياً أن الكتابة الجاهلية ، من حيث خطها و أبجديتها ترجع إلى قلمين : أحدهما القلم المسند ، وهو الذي دونت به الكتابات المعينية و السبئية و القتبانية و الحميرية و الأوسانية ، وكلها لهجات عربية جنوبية . و ثانيهما ، القلم النبطي المشتق من الخط الأرامي المتأخر ، وهو الذي كتبت به الكتابات الوحيدة الواصلة إلينا من الجاهلية و المشار إليها في هذا الكلام . أما الكتابات الثمودية و الصفوية و اللحيانية فهي مدونة بخط مشتق من القلم المسند . و هذا – أي المسند – أقدم عهداً من القلم النبطي ، و تدل الكتابات المكتشفة في شبه الجزيرة العربية و المكتوبة بالقلم المسند أن هذا القلم كان شائعاً في بلاد العرب قبل الميلاد و بعده* . “راجع : حسين مروة – النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية – دار الفارابي – بيروت – الجزء الأول – الطبعة السادسة ١٩٨٨م – ص ٢٤٧ . ” . )) من كل ما سبق نجد ان الكتابة قد وجدت و عرفت في شبه الجزيرة العربية قبل الميلاد و بعده حيث شاع القلم المسند و القلم النبطي ، فهي ليست معدومة او مستجدة على الصحابة الذين كتبوا بها القرآن الكريم، و المعاهدات و الرسائل . و في بحثه التوثيقي لمعنى ( *الأمي* ) غير الكتابي، يقول *د. إبراهيم أنيس : ( تذكر المعاجم القديمة لكلمة الأمي معنيين أحدهما هو المألوف الشائع بيننا الآن، و الآخر معنى غريب غير مستساغ هو على حد تعبيرهم ( العيٌ الجافي الجلف القليل الكلام )* . و لست أدري *كيف استباح أصحاب المعاجم لأنفسهم أن ينسبوا مثل هذا المعنى لكلمة الأمي بعد أن وصف بها النبي في القرآن الكريم، و كيف يتصور أن يكون للكلمة مثل هذه الدلالة في أذهان العرب ، ثم مع هذا تتخذ وصفاً لنبيهم في قوله تعالى : { الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر }* الآية ١٥٧ سورة الأعراف . و قوله : *{ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ }* سورة الأعراف الآية ١٥٨ *و الغريب أننا لا نرى أي أثر لهذه الكلمة في جمهرة ابن دريد ، و لا في صحاح الجوهري ، و لا في تذييل الصاغاني* ، فلم يرد لها ذكر في هذه المعاجم على سعتها و كثرة ما جاء فيها . و يبدو أن كلمة *الأمي* من الكلمات التي لم تكن شائعة في الإستعمال قبل الإسلام، فلا نعرف لها نصاً صحيحاً من نصوص الأدب الجاهلي ، و لا نعرف أن العرب قد اشتقوا لها فعلاً ، أو غيره من أنواع المشتقات . و مهما يكن من أصل هذه الكلمة ، *فالذي يبدو من استعمالها القرآني أنها وصف لا يراد به الحط من شأن الموصوف أو الانتقاص من قدره ، بل يوصف به من ليس من أهل الكتاب ، سواء كان يقرأ و يكتب ، أو ممن لا يقرأون و لا يكتبون* . ففي قوله تعالى :*{ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر }* الآية ١٥٧ سورة الأعراف . و قوله : *{ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ }* سورة الأعراف الآية ١٥٨ ، *يدعو سبحانه أهل الكتاب من بني إسرائيل أن يؤمنوا بذلك الرسول الذي ليس منهم* ، و الذي ورد ذكره في كتبهم . وقد اقتضت حكمته أن يكون ” محمد ” *من غير أهل الكتاب* ، خلافاً لما جرت به السوابق من اختصاص أهل الكتب المقدسة بالرسل و الأنبياء . فجميع أنبياء بني إسرائيل من بينهم ، و ممن نشأوا في ظل الكتب المقدسة التي أنزلت من قبل ، فأصبح القوم وقد خيل إليهم أن الرسول الحق لا يكون إلا منهم ، كأنما كانت النبوة أمر وراثة فيهم . … و مما يرويه المؤرخون الثقات *كالبلاذري في كتابه فتوح البلدان حين يقول : [ دخل الإسلام و في قريش سبعة عشر رجلاً كلهم يكتب* … ] .. )) ” راجع : د. إبراهيم أنيس – دلالة الألفاظ – الطبعة السادسة عام ١٩٩١م – مكتبة الأنجلو المصرية – ص ١٨٧ إلى ١٩٢ ” ” كذلك راجع : محمد أبو القاسم حاج حمد – العالمية الإسلامية الثانية – المجلد الأول – الطبعة الثانية عام ١٩٩٦م – دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع بيروت لبنان – ص ١٥٣ إلى ١٦١ ” . *نتائج البحث :* (١) – انحصر معنى كلمة” *الأمي*” في أمة و جمعها أمم بمعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم *أرسل إلى الأمم كافة وليس إلى بني إسرائيل . و المعني الأخر في أن ” الأمي*” وردت في القرآن بمعنى *غير الكتابي و ليس غير الكاتب* الذي يجهل الخط و القراءة . (٢) – ثبت بالقرآن أن الرسول لم يكن يخط بيمينه ولا يقرأ الرسوم، الآية : *{ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ }* الآية (48) سورة العنكبوت(٣) – ثبت ان الكتابة كانت معروفة منذ القِدم في جزيرة العرب، و أنهم كانوا يكتبون و يحسبون تجارتهم . (٤) – أن المعنى المتداول لكلمة ” *أمي*” في عدد من المعاجم و القواميس العربية بأنه ( *الجاهل ، العي ، الجلف و قليل الكلام*)، معنى لا يليق بخاتم الرسل والأنبياء الذي علمه ربه و أدبه فأحسن تأديبه . (٥) – أطلق القرآن الكريم لفظ ” *أميون*” على اليهود الذين جهلوا كتابهم و طفقوا يحرفونه و يدسون فيه ما ليس منه ، أي جعلهم أميين غير كتابيون لجهلهم و تحريفهم للتوراة ، مع انهم يكتبون الخط و يقرأون الرسم ، و في قوله تعالى : *{ و منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني و إن هم إلا يظنون * فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ }* سورة البقرة الآية ( ٧٨ – ٧٩ ) .(٦) – إتفق العالمان ميرغني ، و حمد ، على أن العرب كانوا يكتبون و يحسبون ، و أن الأمي لا تعني الجهل بالكتابة و القراءة ، و إختلفا في معرفة الرسول بالخط و قراءة الرسم فأكدها ميرغني و نفاها حمد ، كل بادلته و اسانيده ، كما اختلفا في تحديد المعنى القاطع لكلمة ” *أمي ” فارجعها جعفر ميرغني إلى “الأمة” و جمعها أمم، بينما حددها محمد ابو القاسم حاج حمد بأنها تعني ” غير الكتابي و ليس غير الكاتب* ” وقد أوردا في ذلك ما ذكرناه سابقاً ، و ان كنت أرجح ما ذهب إليه محمد أبو القاسم حاج حمد .
مع تحياتي ،،،*محمد الطيب عابدين* ( كاتب ، باحث ، و قاص )

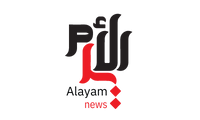


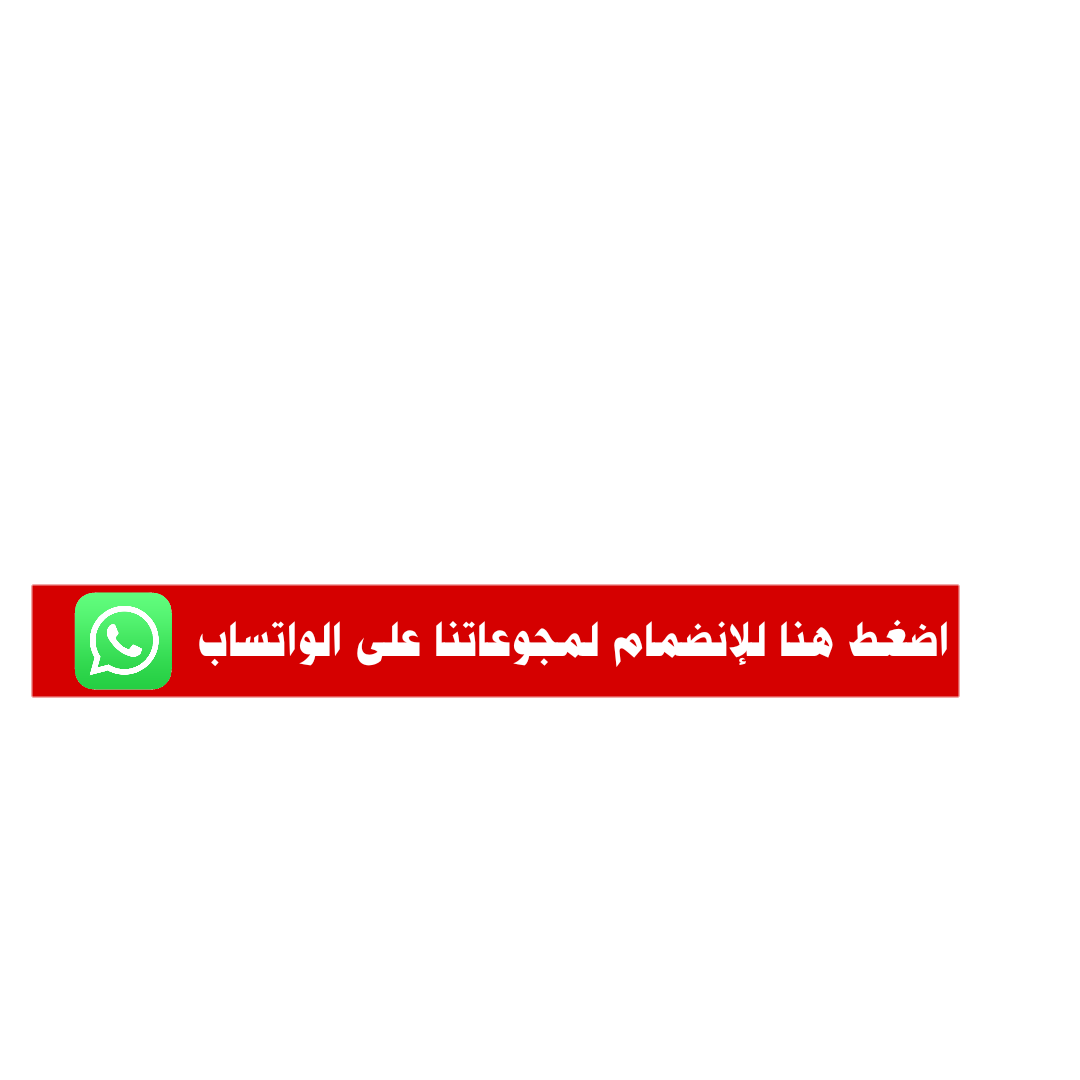
التعليقات مغلقة.